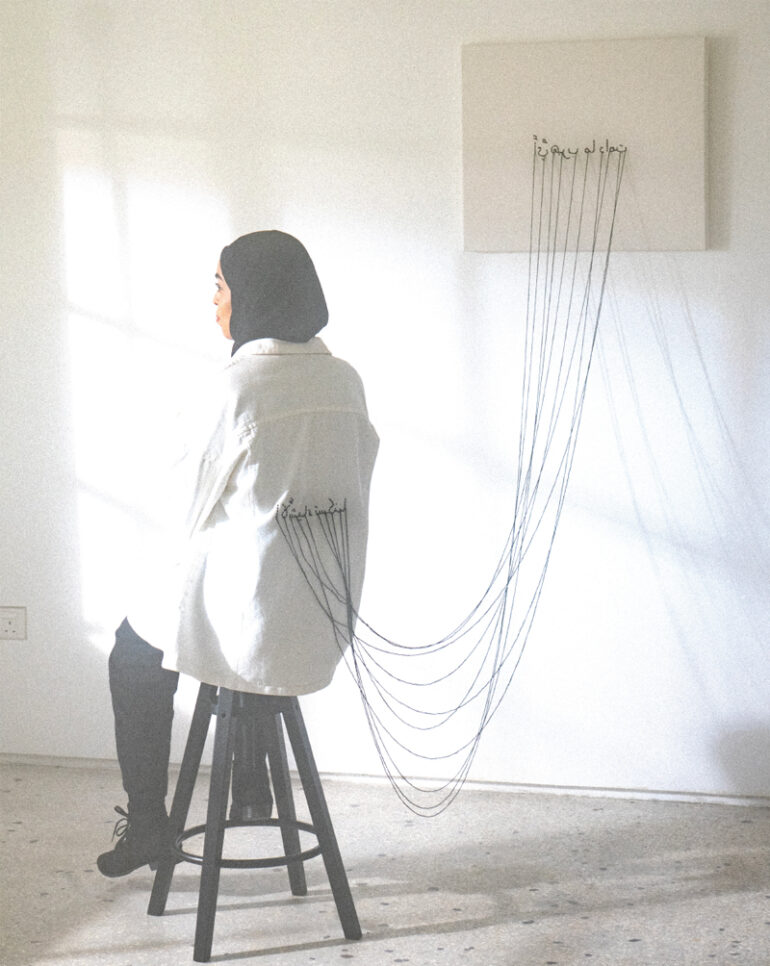ليست صعوبة جاك دريدا من صعوبة أسلوبه أو وعورة فلسفته. كل قارئ جاد ومواظب، يمكنه تتبُّع الخيط الرفيع والنَّاظم لأفكار دريدا، وإن كان الخيط يزجُّ به في متاهة، لكن دائمًا بالضمانة بأن يخرج منها سالمًا. ليست صعوبة دريدا إذن من عقبة الفكرة أو العبارة، وإنما من الوضعية غير المريحة التي ارتضاها لذاته، والتي تتلخَّص في عبارة «بَيْنَ-بَيْن» والتي يمكن تعداد مرادفاتها: البرزخ، المنزلة بين المنزلتين، منطقة الظل، عدم الحسم، الالتباس، الإبهام، إلخ. عندما نكون في هذه الضفة التي ينهار فيها مبدأ عدم التناقض الأرسطي (نسبةً إلى أرسطو)، فنأخذ «هذا» على أنه «ذاك» في شَبَهٍ أو التباسٍ، فإنَّنا بالفعل في الوضعية غير المريحة والحرجة للشرط الفكري. كانت المفردات التي تحتمل الشيء ونقيضه مثل «فَارْمَاكُون» (Pharmakon: السُّم والترياق) في الإغريقية العريقة، و«أَوْفِبُونْغ» (Aufhebung: الاحتفاظ والمجاوزة) في الألمانية، محط اهتمام دريدا، على أساس وقوفه على حافَّة الجُرف، بَيْن-بَيْن، بين الأرض الصلبة للغة ولكنها غير كافية للتعبير عن عُمق النظرة، والفضاء الواسع للنظرة الممكن التحليق فيه ويتطلَّب دعامة لغوية تحتويه.
البَيْنيَّة: السَّرَاب والحِرْبَاء
فهم البَيْنيَّة (بَيْنَ-بَيْن) هو أساس فهم الشَّبحية، ومعرفة الخيط النَّاظم لأفكار دريدا المشتَّتة. ما يدعوه «التفكيكية» ليس شيئًا آخر سوى «عمل النص» الذي يحمل في ذاته تناقضه وتبعثره فيما هو يسعى لأن يُبرهن على قضاياه أو يكشف عن انسجام حججه. تكشف القراءة عن نقيض هذا الادِّعاء، وهو أن النص ينطوي على تناقضات تُشكِّل طبيعته نصًّا متشابك الألفاظ ومتشاجر الأفكار. النص في اللسان اللاتيني هو «نسيج» (textus)، والنسيج في ظاهر نتائجه جميل الانسجام بما يُبديه من سرابيل وأقمصة وفساتين، لكن في باطن سيرورته متشابك الخيوط ومتداخل الألياف. يشتغل النص بطريقة تنزع التَّمركز عن الألفاظ والدلالات، فلا نقف عند «هذه» الدلالة ما لم تُحِل إلى «تلك» الدلالة، التي بدورها تحيل إلى دلالات أخرى، في دَوْرَةٍ تُبرز استحالة القبض على المعنى (Gorman, 2015, p.9). بفرار المعنى من القبض، وبخفَّته الهائلة في التنقُّل والارتحال، فهو يستحيل إلى أثرٍ يتَّخذ صورة طيفٍ أو شبحٍ. الأثر هو ما يتيح الاختلاف بالمعنى الشامل «للتخلُّف» عن الأصل فيما هو يسعى لأن يكون «خليفةً» عنه، مثلما تخلف العلامةُ الشَّيءَ؛ «إنه أصلٌ دون أن يكون أصلًا، الأصل الممحي» (Lucy, 2004, p.145).
الأصل ما يتمُّ تتبُّع أثره دون الوقوف على حقيقته، ومتابعة الأثر هي نظير السَّراب الذي يُشهَد ولا يمكن الوصول إليه، لأنه مفعول النور والحرارة: «فقد أدركتَ ما لا وجود له حقيقةً بل نسبةً، كذلك النور المنبسط على الأرض وتقلب الحرباء في لون ما تكون عليه من الأجسام» (ابن عربي، الفتوحات، 2، ص666). النظر إلى السَّراب دون الوقوف على حقيقته من شأنه أن يُقدِّم شرطًا وجوديًا (أنطولوجيًا) يختلف عمَّا قدَّمته الفلسفة طيلة تاريخها المنطقي واللغوي، عبر المقولات الميتافيزيقية المتداولة. يمكن القول بأن الأثر (وبشكل أوسع «البَيْنيَّة») ينتمي إلى ما سمَّاه ابن عربي «هُوَ لا هُوَ»، في الوقت نفسه عينُه وغيره، بل وكذلك غيره في صُلب عينه، أي «وُجود الضد في عين ضدِّه» (ابن عربي، الفتوحات، 2، ص605). إذا كان الأمر كذلك فإن «التشاكل» بين «هذا» (الضد) و«ذاك» (الضد الآخر) باعتباره صنوه هو ما يثير الحيرة والالتباس، تلك الحيرة التي يكون فيها الحق حاضرًا في كل مكان وفي كل شيء (ألموند، 2011، ص111).
يأخذ الحق من كل صورةٍ لونًا، تجلٍّ على وزن الحرباء، «فلا دليل من الحيوانات على نعت الحق بكل يوم هو في شأن أدل من الحرباء. فما في العالم من صفة ولا حال تبقى زمانين ولا صورة تظهر مرَّتين» (ابن عربي، الفتوحات، ص500). إذا لم يكن بالإمكان الوقوف عل صفةٍ أو حالٍ، فإن المسألة تتَّسم بعدم الحسم (Undecidability) نظرًا للتواتر السَّريع للصور في العالم والتباسها، يكون الموقف إزاءها ليس المعرفة، وإنما الحيرة. والحيرة من الأمر الذي يحور ويدور، يُحقِّق الدَّورة والدُّوار، وفي كل حَوْرٍ هناك تحوير، أي تبديل أو تغيير، فتتبدَّل الأشياء في أوصافها وما تتغيَّر في حقائقها لذاتها. إنما تقف العين على تحوُّلات حرباوية، لا تثبت على حالٍ أو لونٍ، هي أصل الالتباس وسبب الحيرة، ومن ثمَّ عدم الحسم، وتعليق الحُكم بالمعنى الفينومينولوجي للكلمة. يجعل التحوُّل أنطولوجيًا الإحاطة بالأشياء متعذِّرة معرفيًا؛ «استحالة» مزدوجة وملتبسة، في الوقت نفسه «المستحيل» بما يمتنع حصوله، و«المستحيل» بما يتحوَّل باستمرار. عدم الحسم هو إذن الاستحالة بهذا المعنى المزدوج في المُحال والمتحوِّل.
الشَّبَحِيَّة: سِيمْيَاء المسْتَحيل
لا نجد صعوبة في إدراك المسألة عندما نرى بأن الاستحالة بمعنى التحوُّل هي من اختصاص الكيمياء التي كانت في الأزمنة العريقة علم تحويل الخسِّيس إلى النَّفيس، وارتحلت من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية بالتحويل في الذات البشرية، فكان العنوان البارز لدى القدماء «كيمياء السَّعادة» أو الطريقة التي يُنجز فيها الإنسان تحويلًا جذريًا في ذاته يُحقق بموجبه السعادة التي كان يسعى إليها. نقول سيمياء أو كيمياء، فارقٌ ميَّز كذلك الاختلاف الصوتي والتماثل الرقمي بين السين والشين في النُّطق العبري، وقف عنده دريدا بالكلمة «شيبُوليت» (Schibboleth)؛ تماثُل طفيف ينمُّ عن اختلاف جذري. إذا نظرنا إلى السيمياء والكيمياء من حيث الجذور الرقمية، بين «سِيمْيُون» (العلامة) و«كِيمِيَّا» (الخليط)، نُدرك أن الأخلاط التي تمتزج ويصدر عنها معدن أو حالة، هي علامات تتشابك ليخرج منها صنف معيَّن.
يكمن الفارق في أن العرب قرأت الكاف على أنه الخاء في الكلمة الإغريقية، «خِيمِيَّا» (Khêmeia) بدلًا من «كِيمِيَّا»، فكانت الخيمياء هي فن تحويل الخسِّيس إلى النَّفيس، واقعيًا بتحويل المعدن إلى ذهب، ومجازيًا بتحويل الرذائل إلى الفضائل. يختلف الأمر مع «سيمياء» التي هي وصفية وتنعت علامات، مثل علامات المرض، لكن تتمفصل بالتحوُّل، بأن تقف على علامات التحوُّل من حالة إلى أخرى، من الهزال إلى القوة أو عكسه. يمكن الوقوف على هذا الربط في المصطلح «سِيمْيَا» وهي الكيفية التي تمتزج بها القوى ويحدث عنها فعل غريب (الأحمر، 2010، ص31)، والذي كان في هذا المدلول المبدئي يشير إلى السِّحر والشعوذة. غير أننا نأخذ بإطار الفكرة الذي هو التحوُّل وليس بمضمونها الخرافي. بالمعنى الخرافي، يمكن دائمًا القول بأن السِّحر والشَّعوذة يُسهمان في استحضار الأرواح، بالإيهام والتمويه، على غرار المعدن الذي يستحيل ذهبًا وما هو بذهب.
لذا نقول «سَحَر الفضَّة» أي طلاها بالذهب. غير أن الأرواح التي تتجسَّد والتي ندعوها أشباحًا أو أطيافًا، ليست بهذه الخرافة التي نظن. ليست الأشباح أرواح الموتى المسمَّاة أيدولة أو «أيْدُولُون» (eidôlon)، وليست كيانات شفَّافة ولطيفة، خيِّرة أو شريرة، التي تُصوِّرها السِّينما في أفلام الرُّعب. الأشباح هي الاسم الآخر للبينيَّة، الحضور والغياب في الوقت نفسه، أو الحضور في عين الغياب: «الشَّبح هو تجسيد يتَّسم بالمفارقة، صيرورة الجسد، شكل ظاهر وجسدي للروح» (Derrida, 1993, p.25). بهذا التعريف يُقدِّم دريدا ما هو عليه الشَّبح من عدم الحسم: لا هو نفس ولا هو جسم. إنه منزلة وُسطى بين حقيقتين، إحداهما مادية والأخرى غير مادية. والتجسيد لا علاقة له بالتجسيم. نقول «الروح يتجسَّد» ولا نقول عنه أنه يتجسَّم.
الشَّبَح من الشَّبَه: الحَيْرة والالْتِبَاس
السينما في نظر دريدا هي آلة في صناعة الأشباح، لأن البينية التي يتَّسم بها الشبح هي تناقض في الحدود: نرى شخصًا قضى نحبه وهو حيٌّ في الشريط السينمائي. نراه وقد انقضى، هو لا هو. إنه وجود الغياب (الماضي) في الحضور (الحاضر). الشبح من الشبه: «كأنه هو». من هنا كان الالتباس بين العرش الحاضر في عَيْني ملكة سبأ والعرش الغائب وهو عرشها الحقيقي: «قِيلَ أهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأنَّهُ هُو» (النمل: 42). من ثمَّ فإن الشبح يختفي في عين ظهوره، «كأنه هو»، كأن الشبح هو الشخص، لكن ليس هو الشخص، لأن الجسد الذي حلَّ به ليس الجسم المادِّي الملموس. إنه طيف: «إن الطيف كألوان الطيف متعدّد ومتغيِّر، يترك فينا انطباعات الدهشة والغرابة، أو الخداع والمخاتلة. يتميَّز الشبح بكونه غير ساكن، فهو دائم الانتقال والارتداد مثل ظل الإنسان الذي يتمدَّد أو يتقلَّص بتغير الأوقات بين الصبح والظهيرة أو العصر والمغرب» (بكاي، 2011، ص127).
يُوحي الشبح بالوهم ويثير الهيام، شبيه بالصور التي يراها النائم وكأنها واقعية وهي فقط مفعول الخواطر المتسارعة، أو التي يراها المشاهد في السينما وكأنها حقيقية، وهي مفعول التأثيرات الخاصة من صُنع الحواسيب. تُعطي هذه الصور المتكاثرة، والمتعدِّدة، والمتردِّدة الانطباع بواقعية المشهد وهو خيالي (النائم) أو افتراضي (المتفرج)، وكأن هذه الصيغة تُذكِّرنا بالقاعدة الباروكية في خيالية الوجود: «الحياة حُلم»، يقول الكاتب الإسباني بيدرو كالديرون دي لا باركا، أو «المسرح الكبير للعالم» حيث كل واحدٍ منَّا هو «مُمثِّل» حياته، كالممثل الذي يُحقق التناقض الظاهر بين الغياب والحضور، يُمثِّل غيابًا (شخصًا عريقًا) في حاضر التمثيلية، «خيال في خيال» بتعبير ابن عربي، «خيال» التمثيل (يُمثِّل الحيُّ الشخص الرَّاحل وليس هو)، و«خيال» المرجعية (مجرَّد مسرحية لا علاقة لها بالواقع).
في الجذر اللغوي نفسه، ينبري «التمثُّل» بصفته استحضار الغائب (Re-presentation)، أي أن الغائب «يَمثُل» في الذهن (التخيُّل) أو في الآلة (الشريط السينمائي)، كالجاني الذي يَمثُل أمام المحكمة. «مُثُول» الغائب هو حضوره بالنيابة، ينوب عنه ممثِّل (المسرح) أو تمثيل (السينما). التمثُّل هو ما يعود مختلفًا أو مغايرًا في كل مرَّة، والممثِّل هو من يؤدِّي أدوار حدثٍ يتكرَّر في نُسخ متواترة، في كل مرَّة هو عينه وغيره، هو لا هو، يختلف عن ذاته، ويتخلَّف عن أصله. للشبح عَوْدة بتصاريف متنوعة: «العَوْدة» بمعنى الرَّجعة في شكلٍ مغاير؛ «العِيد» بالاحتفال بشخصٍ أو حدثٍ هو الرجوع الطيفي لذلك الشخص أو الحدث؛ «العَادَة» بما يتكرَّر من تقاليد وأعراف يصبح فيها المصنوع مطبوعًا أو تصير الثقافة طبيعة ثانية. لأن ما يتكرَّر يميل إلى الدَّوام، أي يُحقق تلك البَيْنيَّة،
من جهة التكرار بالعَوْدة المستمرَّة، ومن جهة أخرى الثبات بصيرورة تلك العَوْدة المستمرَّة حدثًا ثابتًا يتكرَّر بانتظام.
التَّلْويح بَيْن التَّلْميح والتَّصْريح: من أجْل فَلْسَفَة بَيْنِيَّة
عودة الأشباح هي ما يُميِّز العصر، بمختلف الاحتفالات الموسمية، والصنائع التقنية والسينمائية، والمبادلات الرقمية والمالية. يقول ماركس «جسد النقود عبارة عن ظل» (Derrida, 1993, p.80)، أي ما نتداوله ويتكرَّر في نظام المبادلة والمعاودة هو وهم أو طَيْف، من حيث أن النقود تنوب شيئًا متحوِّلًا هو القيمة التبادلية، ومن حيث أن النقود نفسها تغيب في عين حضورها في بدائل أخرى مثل بطاقة الدفع، والتحويل الصرفي، والعملة الرقمية المشفَّرة مثل «بيتكُويْن». ارتحل المادِّي إلى الافتراضي بأن اكتسب «جسدًا لطيفًا» يختلف عن «الجسم الكثيف» (المعدن أو الورق). يبدو كثيفًا في عين لطافته، لأن الكثيف هو موضوع اللمس، واللطيف يُرى ولا يُلمَس، أو لا يُرى لكن يُشعَر به. الروح والشبح، اللذان يقتسمان جذرًا مشتركًا، لهما هذه الخاصية المعكوسة في الظهور غير الملموس بالنسبة للشبح (Ghost) والبطون المشعور به بالنسبة للروح (Geist).




الكلمة الألمانية Geist التي تقول معنى الروح (Spirit) هي التي تُحقِّق البينية المنشودة، لأن الروح بالمعنى العربي أو المعاني اللاتينية في الإنجليزية والفرنسية تنعتُ كيانًا خفيًّا وشفَّافًا، بينما الكلمة الألمانية Geist تقول في الوقت نفسه الشفَّاف والكثيف، وأبلغ تشبيه هو ما وصف به الشاعر يوهان غوته الروح بأنه نظير «زَبَد البحر»، والزَبَد هو ما يُحقق كثافة الرغوة وشفافية الماء، في الوقت نفسه ما يُرى وما لا يُرى، من جهة الرغوة البيضاء ومن جهة أخرى الماء الشفاف. عندما نتحدَّث عن روح الكلمات، أو حتى عن روح العالم: «رأيتُ روح العالم يمتطي جوادًا» يقول هيغل بشأن الإمبراطور نابوليون وهو يغادر مدينة يينا الألمانية، في رسالة إلى صديقه نيتهامر بتاريخ 13 أكتوبر 1806. بهذا الروح نتكلَّم عن برزخٍ يُمثِّل شيئًا ما، يقع في الشَّرط البَيْني للإنسانية، «بَيْن» كثافة الإنسان الواقعي (نابوليون) ولطافة الإنسان المتعالي (روح العالم): «تُنتج الرَّوْحَنة الشَّبح» يقول دريدا (Derrida, 1993, p.203)، لكن لا رَوْحَنَة دون جسد، والجسد ليس الجسم: «شكل الظهور، الجسد الظاهر للروح، ذلكم هو تعريف الشبح» (Derrida, 1993, p.216).
مثلما للظهور الشبحي المتجسِّد تعليل أنطولوجي، للظهور الشبحي اللغوي تعليل فلسفي. تكمن شبحية اللغة في التَّلويح الذي يقع بين التلميح والتصريح، أو المُسارَّة بين الإشارة التي تُلمِّح والعبارة التي تُصرِّح. التلويح هو مسألة سر أو سريرة، من حيث أن الفعل «لاحَ» يقول الفعل ظهر وتلألأ، لكن يُخفي دائمًا شيئًا ملغزًا. يختفي في عين ظهوره، ولا يُبدي سوى ما يمكن إعمال التخمين أو الحدس بشأنه. كذلك، يقول الفعل «لوَّح» شيئًا من الظهور واللَّمعان كالسَّراب البادي عن بُعد «يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً» (النور: 39). مفعول الظهور هو زَبَدي أو رَغَوي، لأنه شفَّافٌ تجلَّى في كثيفٍ بمفعول الرجرجة والتلاطم. من ثمَّ فإن الفعل «لوَّح» يقول بمقلوبه اللغوي والمرآوي «حوَّل» شيئًا من التغيير والإحالة والحَوْل. لا يمكن للمعنى الذي يلوح في سطوح اللغة أن يكون إشارةً تُلمِّح هي من عُنصر الباطن أو عبارة تُصرِّح هي من باب الظاهر. التلويح اللغوي هو عين التحويل الدلالي بالإحالة والمجاوزة؛ يُؤجِّل، ويُرجئ، ويتروَّى. التلويح من جنس الإرجاء والرجاء، لأنه عالم مفتوح على الإمكان، والاحتمال، واللاتوقُّع.
السِّرُّ والتَّلويح: الأنَا والآخَر
يقع التلويح في نظام السِّر، عندما تنفرد الإشارة بالتلميح ونظام السِّتر، والعبارة بالتصريح ونظام النَّشر. وإن كان بين التلويح والتلميح لطيفة ودقيقة، فهي كما يُضمر السِّتْرُ السِّرَّ: السِّـ(ـتـ)ـر. لكن ينفرد السِّر بنظامٍ في رَوْحنة جسد اللغة، ما يظهر في عين تواريه أو عكسه، ما يتوارى في عين ظهوره؛ فيما يبقى الستر متواريًا والإشارة مغلَّفة. لماذا السِّر؟ لأنه الكيان الوحيد الذي يفتح نافذة من داخل عالمه المغلق؛ شيءٌ شبيه بالمونادا (أو الذرَّة الروحية) عند الفيلسوف ليبنتز. يفتح السِّر من داخل شرطه الجوَّاني نافذة نحو الآخر، «والآخر سر لأنه آخر» (دريدا)، في الوقت نفسه البادي بخِلقته وأفعاله وملامحه، والمتواري بأسراره وخواطره ومقاصده ونواياه. غير أن وجه التَّلويح في الآخر هو ما يُمكن تسميته السِّرَر أو الأسارير أي خطوط الجبهة وملامح الوجه التي تُنبئ عن حالٍ ما كحال الفرح أو الترح. ليس التفكيك شيئًا آخر سوى «إمكانية تجربة السِّر التي ليس لها شيئًا تقوله» (Derrida, 2003, p.27)، لكن لها الشيء الكثير تفعله.
ليست تجربة السر ككل التجارب، فهي تجربة بَيْنيَّة، بين الإخفاء والإفشاء، بوضع أحدهما في «عين» الآخر، الظهور في «عين» الغياب وعكسه، الأنا «مثل» الآخر ونظيره، ولا يكون الأنا «مثل» الآخر سوى عندما يشهدُ تجاربه، ويُعاينُ ما يُعانيه، ويُدرك مآسيه بالنيابة أو الاستشعار (empathy). لأن النِّظارة البشرية في حدس ما يختلج في السَّرائر تقول كذلك النَّضارة الإنسانية في الاشتراك حول التسامح (على وزن التفاعل): ما أبيحه لذاتي أبيحه لغيري. وليس أبلغ تعبير عن هذه الإتاحة والإباحة التي تقول عُمق الوقار سوى ما قاله غادامير: «عليك دائمًا أن تأخذ في الاعتبار إمكانية أن يكون الآخر على حق. إنها روح التأويلية ذاتها» (محاضرة بجامعة هيدلبيرغ، بتاريخ 09 يوليو 1989). ليس هناك من تجربة في السِّر سوى الاستشعار بهذا البُعد الكوني «المونادي» الذي يشدُّ أوتار البشر إلى بعضهم بعضًا في إيقاعٍ بليغ أو سيمفونيا سائغة، كون السِّر هو ما أراه متجسِّدًا في المشترك البشري من روح الحوار والتسامح. نعتها غادامير بروح التأويلية ذاتها، ما دام الفهم الذي تأسَّست على قواعده التأويلية هي في جوهرها روح التفاهم.
وعليه، فإن تجربة السِّر أو نظام التلويح ما يجعل ممكنًا هذه الفلسفة الحوارية. الإشارة هي في مقام البطون المستور، والعبارة هي في مقام الظهور المكشوف؛ الأولى تنأى بالنفس وتفرُّ إلى عالمها، والثانية تطغى بما تريد قوله، فتتخطَّى حدودها في عراكٍ أو نشازٍ. وحده التلويح الذي يقول التحويل في نظام العلاقة بين البشر. ولم تكن الفلسفة، في نهاية المطاف، وبعد الطواف حول هذه الأطياف، سوى التحويل الذي يُجريه كل واحدٍ على ذاته، بالسيمياء في الاستحالة، أو الكيمياء نحو السَّعادة، في شكل «رياضات روحية» (Hadot, 1995, p.80) كفيلة بربط الإنسان بذاته تكوينيًا، وتصرفه عن الخروج من حدود ذاته نحو قهر أغياره من وراء تمركزٍ وغرورٍ أو اصفاءٍ وتميُّزٍ. تجربة السِّر هي الفلسفة البينية التي تُعلِّم كيف يحيا الواحد «وسيطًا»، يُيسِّر العلاقات، ويُسهِّل الروابط، ويربط بين العوالم، من أجل حياةٍ مشتركة تكون فيها «إمكانية أن يكون الآخر على حق» منتهى فلسفة التسامح وسيمياء الشبحية: ليس الشبح ما يُخيف بمظهره، بل ما يُبرز أنه روح يتسامى عن الفظ والسَّمج. إنه عنوان التواري والتواضع في عين الظهور والارتفاع.
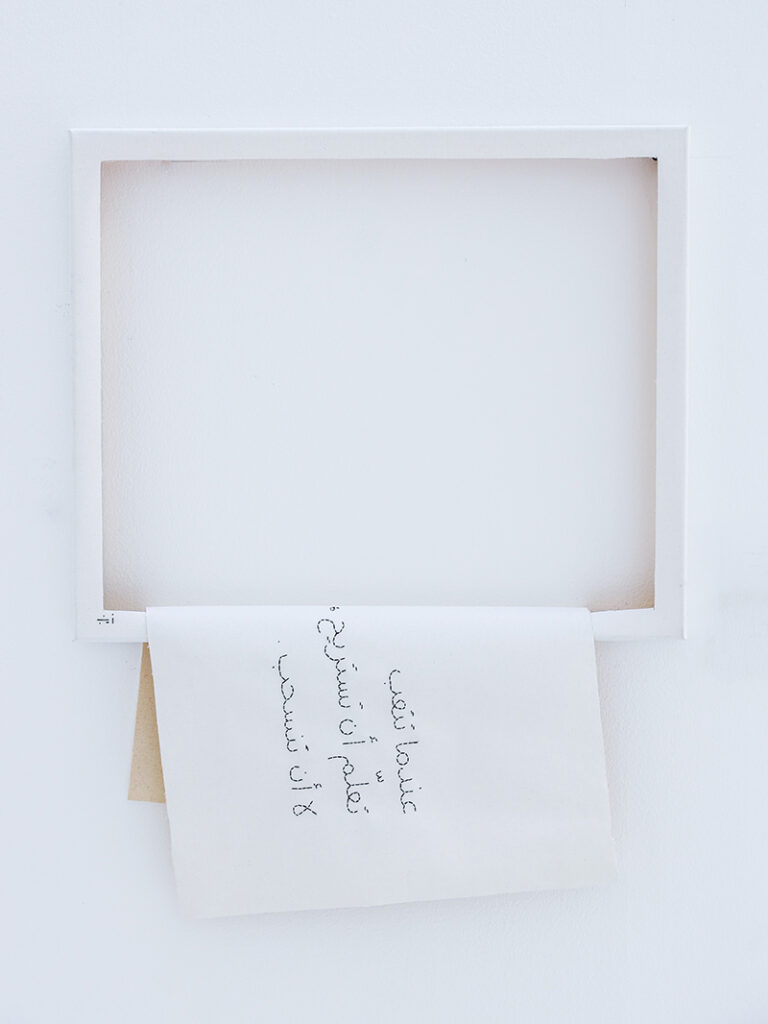
المراجع
- الأحمر، فيصل (2010)، معجم السيميائيات، الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات الاختلاف، بيروت-الجزائر، ط1. (Source in Arabic)
- ابن عربي، محي الدين (د.ت.)، الفتوحات المكية، دار صادر، بيروت.
- ألموند، أيان (2011)، التصوف والتفكيك: درس مقارن بين ابن عربي ودريدا، ترجمة حسام نايل، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط1.
- بكاي، محمد (2011)، «مقولة الشبحيَّة عند جاك دريدا»، جاك دريدا: ما الآن؟ ماذا عن غد؟ إشراف محمد شوقي الزين، دار الفارابي ومنشورات الاختلاف، بيروت-الجزائر، ط1.
- Derrida, Jacques (1993), Spectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle Internationale, Paris, Galilée.
- Derrida, Jacques (2003), Genèse, généalogies, genres et le génie. Les secrets de l’archive, Paris, Galilée.
- Hadot, Pierre (1995), Philosophy as a Way of Life. Spiritual Exercices from Socrates to Foucault, Trans. Michael Chase, Introduction by Arnold I. Davidson, Blackwell: Oxford-Melden.
- Lucy, Niall (2004), A Derrida Dictionary, Blackwell Publishing: Oxford-Melden.
- Gorman, Clare (2015), The Undecidable: Jacques Derrida and Paul Howard, Cambridge Scholars Publishing: Newcasle (UK).
باحث وأكاديمي،أستاذ التعليم العالي في الفلسفة بجامعة تلمسان (الجزائر). درس الدراسات العربية الإسلامية بجامعة بروفونس (فرنسا) وتحصل من جامعتها على الدكتوراه عام 2004 في مجال التصوف والتأويليات؛ ثم تحصل على دكتوراه ثانية في الفلسفة من جامعة أكس-مرسيليا (فرنسا) عام 2011 في مجال الفلسفة العملية ونظريات اليومي.